عباس بيضون
من المفارق ان يغدو خطاب مجلة شعر هو الخطاب الرسمي للحداثة، المفارقة هي في ان الخطاب الذي تكوّن في الهامش أصبح سائدا والذي بدأ ثوريا انتهى الى ان يكون مشروع مصالحة. لست داروينيا في هذا المجال لأتكلم عن البقاء للأصلح، فما يبقى في ثقافتنا ينبغي ان يكون عرضة لمساءلة أخرى. بيد ان من المهم ان نعرض بإيجاز لعناصر أساسية في الخطاب الشعري للمجلة الراحلة.
إذا تحدثنا عن الرسالة والمرسل والمرسل اليه فإن خطاب <<شعر>> قام على نزع الطبيعة الابلاغية عن اللغة التي تغدو هكذا منوطة بنفسها، واجدة في ذاتها رسالتها وربما موضوعها. قاتمة على تأمل نفسها او التوليد من ذاتها. لعل الاتكاء على <<كيمياء اللغة>> الرامبوية لم يعن لمؤسسي الحداثة شيئا سوى هذا التوليد او التحويل الداخلي. بينما لم يكن تخريب اللغة سوى عملية داخلية أيضا. أي ان الحلم بفك اللغة عن إشاراتها الموروثة وربما أنظمتها الصرفية والنحوية كان نوعا من العودة الى داخلية اللغة وتحريرها من أي التزام تجاه الخارج، جريا على ذلك يمكننا الكلام عن قطع الشعر نسبيا عن كل داع خارجي، او تحويل هذه الدواعي سواء كانت المناسبة أم الموضوع الى عنصر ثانوي. يتوقف الشعر عن ان يكون جوابا على أي طلب خارجي، مناسبته في ذاته وربما موضوعه وبالطبع غايته. انه يتأمل ذاته ويولد منها. معياره فيه ورسالته منه إذا جاز التعبير، هذا القطع عن الخارج يستمد ثقافته وربما معانيه من أيديولوجيا معادية للحاضر، أيديولوجيا كهذه تبقى مفتوحة على آفاق متناقضة. لكن ذاتية اللغة والشعر كانا في أساس مطولات شعرية تستنفر اللغة بكاملها (ومعها التاريخ والثقافة) فإن هذه الأعمال لم تنج بالطبع من أيديولوجيا متعالية واعتراضية في آن معا، بل ان نفي الأيدويولجيا لم يحل دون حمل <<أغاني مهيار الدمشقي>> و<<سن>> من الجهة الأخرى بيانات أيديولوجية متكاملة، والحال ان قطع الشعر عن الخارج كان أحيانا تعاليا عليه <<الخارج>> واستتباعا له بقدر ما هو عبادة للشعر ورفع له فوق الثقافة وفوق التجربة وتحويله الى معلم تحرير وفاتحة للمستقبل.
يعني ذلك قيام الشعر بأكثر من الغناء، بل قيامه مجازا بالثقافة كلها، من هنا طبيعته المتناقضة، انه يعود الى ذاته لكن ليحولها الى متروبول ثقافي ولينيط بها ان تمتص وتبتلع الثقافة بجملتها، يتحول الشعر بذلك على نحو غامض الى ديانة للمستقبل وإلى تاريخ بديل وإلى ثقافة شاملة، هذا الموقع العلوي للشعر جعله تقريبا أعلى من نفسه، إذ غدا ذا كثافة لا يبقى معها مجرد هامش غنائي، انه الفكر والثورة والنهضة في آن معا، من هنا لا يعود الشاعر هامشيا رغم التغني بالانفراد والوحدة، انه الرائي والمتنبئ والموقظ والسابق والمجنون والمحرر والرافض والموبوء، أي انه نوع من <<بابا مستقبلي>> ومن قطب ومن إمام ومن محرر. هكذا بالطبع يصل الشعر والشاعر الى حد الاستحالة ويصطدم كل بمرآته.
في ما ذكرته أعلاه بالطبع نوع من مونتاج لا اتفاق على صحته، لكن الغريب ان هذا المشروع الباذخ العملاق هو الذي بقي، ولم يبق بالطبع لامكانه وعمليته بل ربما بقي بالضبط لأنه لا يطرح مهمة مباشرة، كان على الشعر ان يتملى من ذاته وأن يتعالى بها وأن يحلها مركزا وقطبا وكل ذلك لا يحتاج الى برهان ما دام موجودا بصورة قبلية فيه، ليس عليه إلا ان يتطابق معه او يدعيه ليتحقق ويكون. الغريب ان مشاريع أخرى أكثر تواضعا لم تجد سبيلا الى البقاء لا لشيء إلا لأنها طرحت على نفسها مهمة يمكن قياسها وامتحانها، ساء مصير نظرية عبد الصبور في الشعر لأن شعرا بلغة جارية واجه ممانعة قوية من البنية اللغوية والايقاعية ليس أدل عليها أكثر من شعر عبد الصبور نفسه. ساء أيضا مصير الشعر المناضل لسبب مماثل، فكل ما كانت المهمة مباشرة بدا انها مستحيلة او انها بالعكس عرضة لابتذال وكسل مخيبين، بقي بيان <<شعر>> لأنه لا يلقي على الشعر أي مهمة مباشرة ولأن التهويم النظري في هذا البيان كان كافيا لامتلاء الشعر من ذاته وانطلاقه في نوع من الحرية الوهمية قوامها التوليد الذاتي الى ما لا نهاية. أمكن عندئذ للشعر ان يبدو غير محدود ولا منته ولا محصور في حيز او نهاية او حتى موضوع، لقد بدا نهائيا خارج المساءلة فهو الذي يطرح الأسئلة على نفسه وعلى العالم، استتبع ذلك نفيا لأي مساءلة وكل تطلب مباشر فكان من نتيجة ذلك ابعاده عن كل ممانعة ووضعه خارج أي مقاومة فبدا لذلك سيدا حرا ومطلقا أحيانا هكذا بدا كل اختبار محدد ومباشر مشبوها، أعليت اللغة لكن عزلت عن أي زمن. استحال سؤالها عن صلتها بالكلام او العبارة الجارية او الموروث الشعبي مثلا، بدا، ليس من دون أسباب، ان كل سرد او وصف او موضوع مسمى أمور مشبوهة أيضا، غدا الموضوع السياسي بالاطلاق عدوا للشعر، هكذا احيط الشعر بحائط أمان كبير وعزل عن كل تحد وطرد منه كل ما يقلق استرساله في نفسه.
حملت قصيدة سعدى يوسف بيانا معاكسا: افتتان بالخارجي والمرئي واليومي وأعادت القصيدة الدرويشية الاعتبار للغناء والموضوع والسياسي لكن تجربة السبعينات كانت مدار مساءلة مختلفة للشعر، يمكننا ان نتكلم هنا عن قصيدة النثر (بخاصة سركون بولص وقصيدة النثر اللبنانية وتجربة الجيل التالي من شعراء النثر المتصلة بالاولين)، كما يمكننا ان نتكلم عن الشعر اليومي العراقي، هذان الاتجاهان كانا في أساس تحول ليس متساوقا، فيما كانت التجربة المصرية انقلابا على تجربة عبد الصبور والتفاتا الى بيان <<شعر>> وإن بذرائع يسارية أحيانا، كذلك كان الأمر مع الشق العراقي غير المهاجر، قصيدة النثر في السبعينات تتابعت باحتراف وتمكن الإرث الحديث للقصيدة الجديدة، كانت هذه من ناحية سن نضج لقصيدة النثر، أي سن عمل أكبر على البناء والايقاع واللغة، لكن يهمنا أكثر ان نرى ما في هذه القصيدة من انقلاب الصلة بين اطراف الرسالة الشعرية، لم يعد الشعر قبْليته وتعاليته واستبداليته وانقطاعه الى ذاته وداخليته المطلقة، بدا ان حد الشعري غير قادر على التمايز عن غير الشعري وأن شعرية الخارج لا تقل عن شعرية الداخل. بدا ان اللغة لا تتمرى في ذاتها بل تحتاج هي نفسها الى ان تمتلك جلدا ومادة وملمسا كما بدا ان على الشعر ان لا يجد قوله في ذاته فامتحانه هو توسيع القول والايقاع الشعريين وإيجاد شعرية ما للمهمل والرث والعادي والقذر وأن يكون في مجال عنف العالم وقسوته، اختفى الأسلوب الجميل أمام جماليات الشارع والسوق والمنزل والقاع الجسدي والمديني. لم تعد للشعر تلك الحرية الوهمية المتجلية في توليد ذاتي وسيولة لا نهائية فالقصيدة بدأت تخرج من عباءة الشعر الكبير وتبحث عن كلامها في المكان والسيرة الذاتية والتفاصيل، ذلك يعني ان الشاعر لم يعد أيضا الرائي بقدر ما هو الشاهد والراوية وفي أحيان كثيرة <<البطل الضد>>.
من أين بزغت الثمانينات، احسب انها بزغت تقريبا من قصيدة السبعينات ولا اعرف إذا انفصلت بما يكفي عنها، السبعينات سن نضج قصيدة النثر والثمانينات وما بعدها سن غلبتها، غدت قصيدة النثر بتسارع كبير مهيمنة في كل مكان تقريبا، ومع قصيدة النثر بدا ان الحيز الشعري يفقد حدوده ويتداخل مع النثر، حصل هذا بتوسع جعل الشعر غير مستقل بعد بقاموسه او موضوعه وحتى ايقاعه وبدا أحيانا مقتربا وحساسية وأحيانا تقنية. الأرجح ان مفهوم الشعر لحقه لذلك قدر من الابهام، بدا ان تراث الحداثة كاف لقصيدة الثمانينات وما بعدها لكن تنزل الشعر من الشعر او حتى من الأدب لم يعد قاعدة، انفتحت أبواب أخرى كالسينما بالتأكيد وليست السينما وحدها فهناك الغناء والرواية والمسرح والصحافة. لا شك ان الصورة السينمائية هنا تتداخل بالصورة الشعرية، لا تحتاج الصورة السينمائية الى أكثر من لغة توضيحية والحق ان لغة القصيدة الجديدة في الثمانينات وخصوصا ما بعدها بدت شيئا فشيئا بعيدة عن أي مفهوم سابق للغة الشعرية. اللغة هذه المرة لا تبدأ من الصوت بقدر ما تبدأ من المعنى فانتظار المعنى من التأليف الصوتي لم يعد الأساس، تقصد المعنى وتوليد الايقاع من لعبة المعنى نفسها غلبا. أي ان في تقطيع المعنى وتوازي المعاني وتكرارها وتوزيعها تشكيليا وقصها ووصلها وحسابات النطق والصمت فيها وضغطها وبترها او تسييلها او ترتيبها افقيا وعموديا خطيا وتشبيكيا. تناظرها او تضادها، كل هذا الاشبه بالسيناريو بدا لعبة أخرى للقصيدة، الأمر الذي يطرح مجددا سؤال اللغة وسؤال الايقاع، لا نعرف الى أي حد استطاعت قصيدة الثمانينات وخاصة ما بعدها ان تستوفي هذه اللعبة الأخرى.
اللغة في قصيدة الثمانينات وخاصة ما بعدها غير متعددة الطبقات، انها لغة السطح الواحد، إذا جاز التعبير. لا يناط الأمر الآن بتعدد المعاني واحتمالاتها فهذه القصيدة لا ترتاح للتوليد اللغوي والتناسل اللغوي ولا تحتاج حتى لطبقات المعنى العديدة، ان حصر المعنى مهم لديها، قد لا يكون واحديا لكنه أيضا ليس جنونيا ولا مفتوحا على كل المعاني، ذلك يفترض ان لا يكون للكلام عمق مبالغ به او خفاء لا يدرك. التسطيح لا السطحية بالطبع سمة النص الثمانيني وما بعده، اتكلم هنا عن شيء يشبه التسطيح في الفن التشكيلي وفي بعض الروايات، الكتابة في القصيدة الثمانينية وما يليها مرسومة كما هي في ظاهرها لا في ما ورائها او ايحائها فحسب. التوهيم هنا ليس الأساس ولا السحر ولا الاحتفال، شعراء الثمانينات وما بعدها يحسبون ان الابهام والتوهيم اساسا كتابة مضى وقتها، ان كل هذا البذخ الخيالي ليس ملزما وليس ملزما أيضا الايماء الخفي، الارجح ان هذه الكتابة لا تبالغ في ابتكارها وخصوصيتها وثقلها الايحائي والاسلوب، انها كتابة تأخذ كثيرا بالظاهر وتبتعد عنه بحساب.
ليس في كتابة الثمانينات وما بعدها، هذا الازدواج بين العمق والابهام، بل ليس هناك الايحاء بالعمق عن طريق الابهام، إذ لا يمكن التضحية بكل شيء لإظهار الخصوصية. لنقل ان شاعر الثمانينات وما بعدها يرى ان الابهام والغموض تقليد قديم ولا يرى بالطبع في الوضوح قصور خيال، الوضوح بالنسبة له أساس، والوضوح لا يعني انتهاء الفن ولا ضيق اللعبة وانحصارها إذ يمكن التوليد تحت شمس الوضوح، ويمكن الاستمرار في جدل المعاني وجدل الصور بدون الدخول في مناطق مظلمة.
شاعر الثمانينات لذلك لا يبدو تحت وطأة لا وعي هائج مظلم، الوضوح والوعي ليسا بالنسبة له غير شعريين، كما انه ليس مهووسا بالخصوصية والاسلوب هوس سابقيه، لا تتطلب الخصوصية منه كل هذا الانحراف الكتابي الذي يجعل الشعر في أحيان مستخلصا بالكامل. الارجح ان اللغة كما يريدها شاعر الثمانينات وما بعدها تتميز بشيء من العموم، ليست تماما ابلاغية لكنها في الأساس تواصلية، بعض شعراء ما بعد الثمانينات يبالغون حين يقولون ان اللغة أداة فحسب، الارجح انهم يقولونه على سبيل الاستفزاز والتحدي لكن اللغة مع ذلك ليست حرة تماما ولا خاصة تماما، الاسلوب موجود لكن شاعر الثمانينات وما بعدها ليس عابد أسلوب، وليس الاسلوب عنده كسر كل مشترك وكل عام الى حد نسيان نقطة البداية. لنقل ان شاعر الثمانينات وما بعدها يشترك مع كل فناني العالم الراهن في قلقهم من الخصوصية، ومن التضحية بكل شيء في سبيل أنا الشاعر، يشترك معهم في القلق من التوقيع الخاص ومثلهم لا يحسب ان الفرادة التامة أمر ممكن ولا يخيفه ان يشترك مع غيره في اشياء كثيرة، بل لا يخيفه ان يقال ان كتابته لا تملك طابعا خاصا.
مع ذلك يبدو شاعر الثمانينات وما بعدها مهووسا بسيرته، انها تقريبا موضوعه الوحيد وخبرته الوحيدة التي لا يدخل فيها تعمد او خلق تام، لكن السيرة الذاتية هنا ليست عبادة ما هو ذاتي بل رؤيته وكأنه ليس ذاتيا وتسويته بما هو آخروي وعام، السيرة الذاتية هنا شبه عامة فما يهم منها هو المألوف والمشترك، شاعر الثمانينات لا يبالغ في انفراده ولا يذهب بعيدا في تأمله لنفسه، بل يرى في الغالب نفسه جواب اماكن وأوقات له ولآخرين: الرصيف والشارع والبار والسينما والمقهى ليست مطارح للوحدة، انها دائما لكثيرين، ثم انها ليست مجالا لبطولة خاصة ولا لدراما من أي نوع ولا لتأمل خاص مستوحد، في هذه الأماكن تجنب نسبي للعمق والفرادة وما يكتبه الشاعر هو ما يحسبه لغة هذه الأماكن الظاهرية البرانية القليلة التأدب القليلة الخيال القليلة العواطف القليلة الانفعال، اللغة الوقائعية مع شيء من التذييل الذاتي. انها ليست بالطبع ملحمية ولا غنائية جدا وستكون لذلك قريبة من الكلام، قريبة من الكتابة الصحفية، قريبة من الواقعية الايطالية في افحاشها بالواقع ومبالغتها فيه، وما ينتج عن هذه المبالغة من فكاهة ومفارقة ووقاحة وغلظة، وقائعية هذه الكتابة في جزء منها مداعبة للواقع كما ان السيرة الذاتية فيها بحث عن <<أنا عامة>> إذا جاز التعبير.
تبدأ القصيدة هنا بشبه حكاية توحي في سردها بأنها حكاية كل يوم وكل إنسان، حكاية يبدو وكأنها تقال على سبيل المثال، كأنها سبيل الى القول انها واقعة ليس إلا وان الشعر ليس شيئا آخر، ليس سوى مجرد واقعة بلا تزيين ولا إضافات، هكذا يبدو الشعر وكأنه لا يقصد سوى نقد الشعر وإعادة تعريفه، كأن كل قصيدة تعيد التأكيد مجددا على تعريفها للشعر ونقده.
احسب ان شعراء الثمانينات وما يليها لا يبتعدون في ذلك عن شبه تقليد في القصيدة الحديثة يقضي بأن يعيد الشعر دائما تعريفه للشعر، قبل الثمانينات كان الشعر يقول انه الرفض او التخريب او الاحتجاج او النضال او الحب او أي شيء آخر، شاعر الثمانينات وما بعدها يفعل ذلك وإن بقدر من اللامبالاة او التأفف.
لكن شعراء ما بعد الثمانينات بدأوا يسأمون الحكاية المَثَل هذه بل انتبهوا الى ان هذا قد ينتهي الى تقليد آخر وقد يتحول مع الزمن الى تشابه باعث على السأم وإلى تبسيط شبه تعليمي وإلى حجر جديد على التجربة وتحويلها مجددا الى درس وخلاصة. اظن ان شعراء ما بعد الثمانينات بل ما بعد التسعينات خاصة هم الآن رهن مراجعة لذلك او انه بلغ مداه كما هي العادة، لذا بدأ فن الحكاية الذاتية المبتذلة بالتراجع وأمكن ان يبدأ الشعر من الحكاية وغير الحكاية ومن الأنا والآخر والمعلوم والمجهول بلا فرق لنقل ان شعر الثمانينات وما بعدها هو شعر اللحظة، اللحظة لا اليوم فحسب فقد تذرر الزمن الى لحظات وتحللت الرواية الى لقطات ومشاهد، احسب ان شاعر الثمانينات وما بعدها يسعى الى القبض على اللحظة بأدوات قد يكون بعضها استلهاما للسينما. ان بصرية الشعر مجاورة للحظيته، والارجح ان المونتاج واللحظة الحركية المركبة هما ما يتجه اليه شاعر ما بعد الثمانينات، إذا كانت اللحظة لدى شاعر الثمانينات بسيطة فهي أكثر تركيبا لدى شاعر التسعينات، الارجح ان العموم يحتاج الى وقت ليغدو فناً وأن الواقع لا يستوي بسهولة درسا ومثالا وان الاثر الشعري ليس فقط بخلاصاته وأنه أيضا صلبه وكيانه وتجربته الخاصة، من هنا احسب ان الشعراء يعيدون مجددا مساءلة اللغة والشعر والتجربة بعد ان استنفدوا الأجوبة البسيطة.
ليس هذا بحثا، انه محرض على النقاش، وهو فضلا عن ذلك ذو هنات تاريخية كبيرة مصدرها او أحد مصادرها تفاوت التجربة بين بلد وبلد، فثمانينات مصر غير ثمانينات لبنان ومصر والعراق، وقد يكون كل منها بالنسبة للثاني زمنا آخر.
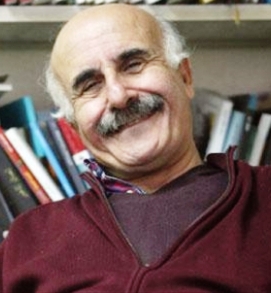






ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق